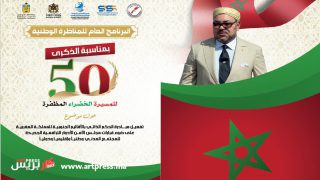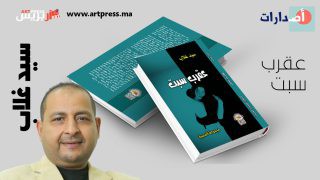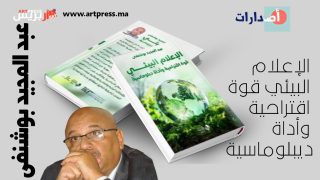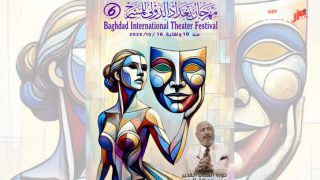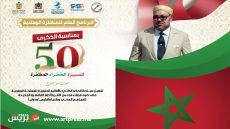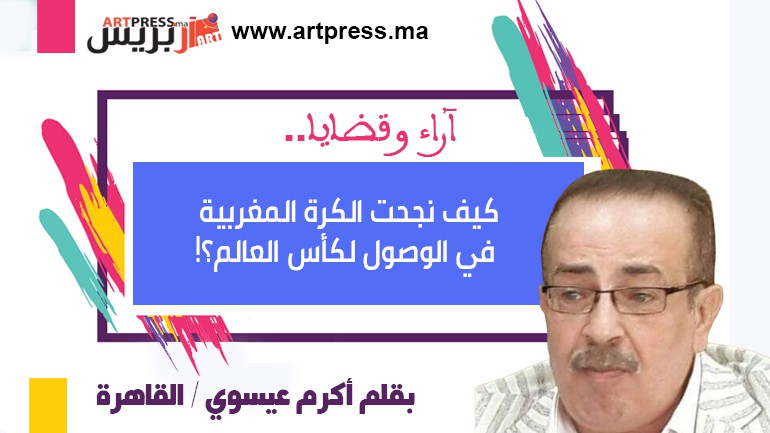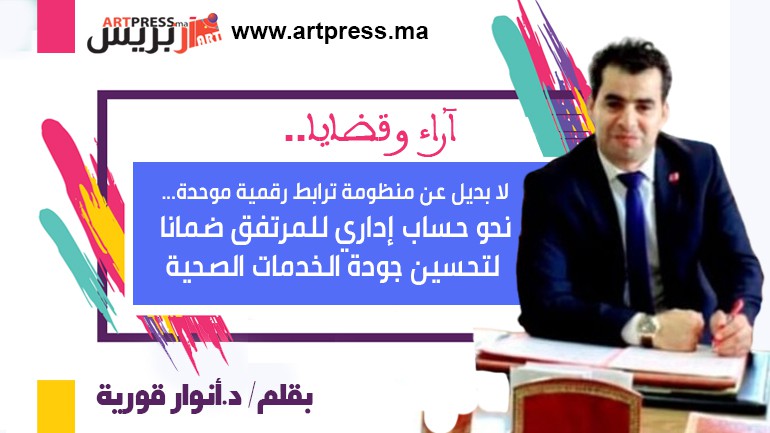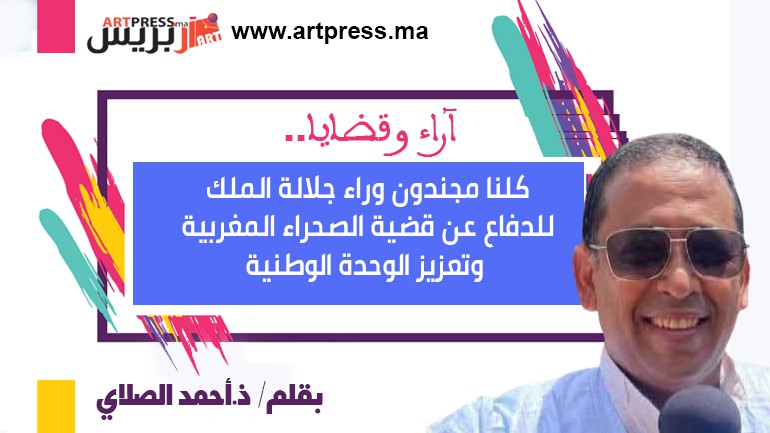إنجاز: د الغزيوي أبو علي
دة بن المداني ليلة
مع نهاية القرن التاسع عشر أصبح أدب العصور الوسطى فرعا من فروع النقد الأكاديمي في الجامعات، مما يوحي بتغير النظرة وتحول الاهتمام إليه، ومع ذلك ظلت خصائص هذا الأدب حاكمة للتوجهات النقدية التي تتناوله، فاهتمت بسياقاته التاريخية، وغلبت عليها الرؤية المقارنة (كما فعل كير 1879. W. P. Ker).
- الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – الجزء 1 – تأليف مجموعة من الكتاب – تقديم وترجمة وتعليق: د. عبد الحميد شيحة – موسوعة الأدب والنقد – المجلي الأعلى للثقافة – 1999.
(دوجلاس جراي Douglas Gray)
ص: 176.
العنوان الأصلي للكتاب: Encyclopedia of literatutr and criticism
Edited by : Martin Coyle
Peter Garside
Malvolm Kelsall
John Peck
الناشر: Routledge, London, 990
وفي السنوات الأخيرة ظهرت الاتجاهات البنيوية، وما بعد البنيوية، والنسائية Feminist، والنزعة التأريخية الجديدة، تغمر هذا الأدب بدراساتها، ومما يبعث على العجب أن يثير هذا الأدب قضايا لم تستطع النظريات الحديثة أن تتجاهلها، ومنها: غياب “المؤلف“، وتزعزع “النص” وتشظي “السياق“، والإحساس “بالاختلاف والائتلاف” في آن واحد، إلى غير ذلك من القضايا المعاصرة.
مجموعة من الكتاب – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1.
دوجلاس جراي
ص 176.
وقد ظل إليوت زمنا محل إعجاب (النقد الجديد New Criticism) وخاصة الحركة النقدية التي قادوا الناقد ف. ر. ليفيز F. R. Lavis في مجلة سكروتيني Scrutiny،ولطالما عارض ليفير مزاعم من زعموا أنه هو وأتباعه قد هونوا من شأن القرن السادس عشر، والحق أن مواقفه النقدية لفتت الأنظار إلى بعض شعراء هذا القرن أمثال توماس وايت، وجاسكوين، إلا أن ممارساته النقدية ذاتها في كتابه إعادة التقييم Revaluation (1936) لم تعر الشعر الإنجليزي في القرن السادس عشر أي اهتمام.
جماعي – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1.
جورج بارفيت Georges Parfitt
ص189.
انصب منهج مجلة Scrutiny والنقد الجديد على النقد التطبيقي Pratical criticism، الذي يتبرأ من المعارف المسبقة أو الخارجة على النص، ولا يرى حاجة إلى معاودة المكتبات واستشارة المعاجم والموسوعات.
جماعي – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1.
ص190.
استأشر الاتجاه النقدي لدى ليفيز ومجلة Scruting بساحة النقد الأدبي الإنجليزي منذ الأربعينات وحتى السبعينات، ولكن نقادا آخرين وقفوا له بالمرصاد، منهم: ف. دبليو بيتيون F. W. Baterson وإ. م. تليارد. E. M. Tillyard ولويس C. S. Lewis، وقد عارض هؤلاء اتجاه ليفيز وأتباعه منهجا ونتائج وتقييما لعصر النهضة الذي تجاهله ليفيز، فيرى لويس أحد المدافعين عن ثقافة العصور الوسطى أن عصر النهضة، وبخاصة الفترة الإليزابيتية، بفضل ثقافة العصور الوسطى “الباهتة” في القرن السادس عشر.
جماعي – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1.
ص 190 – 191.
إن كثيرا من الأحكام الظالمة التي درج الناس إطلاقها وصفا عصر النهضة، إنما صدرت عن كتاب ومفكرين ينتمون إلى التيار السياسي اليساري، ولو راجعوا أحكامهم من منظور أوسع لشملت أيضا ما كتبه آخرون عاشوا في ظلال الحركة الأدبية، وعلى هامش المجتمع، مثل الشواذ جنسيا، وهؤلاء المنتميات إلى الحركة النسائية، إذ من شأن هذا التمحيص النقدي أن يؤدي إلى تعميق الرؤية، وشموليتها ودقتها: ومن ثم لا تكون أحكامنا جاهزة أو مبنية على ظواهر فردية أو مقصورة على جوانب الضعف والشر فقط، بل تمتد لتغطي قيم العصر جميعا بما فيها من خير وشر، وترى نتاجه الأدبي كله من منطلقات مختلفة غير متحيزة إلى فئة دون أخرى، وغير صادرة عن أي إيديولوجية مسبقة.
جماعي – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1.
ص200.
يتضح أن النقاد الجدد New critics قد وجدوا في الحركة الأوغسطية شيئا ما يتطابق مع أولوياتهم الثقافية ويتجاوب مع دعوتهم النقدية (210)، ومرد هذا الشيء إلى أن الأدباء الأوغسطيين كانوا يمثلون في مزيج مراوغ من الفن والطبيعة، والتقاليد والموهبة الفردية – شريحة المفاهيم الثقافية الأساسية تعايشت مع مختلف صيغ الحياة الاجتماعية والسياسية، التي استهدفت منظومة من القيم الأخلاقية هي غاية الاهتمام الإنساني.
جماعي – الأدب والنقد والتاريخ الأدبي – ج1.
ديفيد نوكس David Nokes
ص 210 – 211.
إن الذي يحدد نوعية المسرح في مرحلة ما من مراحل التطور الاجتماعي، هو الحاجة العملية والروحية والخبرات والمثل العليا الجمالية والفكرية بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية في هذه المرحلة، فالمضمون يفرض شكله، وعلى هذا يكون المسرح السياسي وليد ظروف حضارية عربية، أدت بالضرورة إلى وجوده، وأيا كانت المضمونات الاجتماعية والسياسية التي يتبناها الكاتب المسرحي فإنه لا يمكن أن ينفصل عن ظروف واقعه القومي متأثرا به مؤثرا فيه.
ص 49 – 50.
فالمسرح السياسي المباشر، قد يسهم في توجيه الرأي العام، باتجاه معين في فترة محددة، ولكنه يسهم في ترسيخ قيم في تفكير وسلوك الإنسان بشكل ثابت وأصيل، لأن القيم التي يثيرها ويحرض عليها المسرح السياسي المباشر، تكون ذات تأثير وقتي، قد تزول بزوال السبب، وهذا في حد ذاته ليس عيبا، فقد أدى الفن إحدى وظائفه، ولكن الذي نعول عليه أن تبقي القيمة مطلقة وخالدة، فالعناية بالخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأحداث من الأمور الضرورية، لكن تبقى طريقة صياغتها في مسرح سياسي بطريقة غير مباشرة.
ص92.
ارتبط المسرح بالجماهير وتحول إلى وجه معبر عن طموحاته وأمانيه وبلورة قضاياه المصيرية في أعمال فنية تحمل سمات التطلع إلى الجديد وعوامل التحفيز للمشاركة في تبني الرؤية التي تطرح على المسرح أو مناقشة وجهات النظر فيها… أقول حين ارتبط هذا المسرح بالجماهير وأخذ أكثر من شكل وتحولت الحياة كلها إلى المسرح بتجسيد جديد وبخلق فني ممتع، تحولت معها كثير من القضايا السياسية ذات العلاقة بمستقبل إنساننا في أكثر من مكان إلى خشبة المسرح، وأصبحت أحداث الساعة، والأحداث الراهنة الأخرى والتحولات السياسية والانتفاضات الوطنية وأساليب الاستعمار بكل أشكاله، أصبحت كلها سمات تميز مسرح هذا العصر وتغنيه بالجديد المتحرك الذي لا يركن إلى السكون أو الجمود أو مجرد العرض العابر أو النقد الساخر الخالي من كل إثارة للذهن أو تحريك للفكر أو المشاركة الجدلية على أقل تقدير، وبهذا الإطار والمحتوى كان المسرح السياسي علامة من علامات المسرح الحديث الملائم لروح العصر والمتلائم مع التغيرات بل ومع إيقاع الحياة الجديدة التي تنشدها الشعوب في كل مكان، المسرح أصبح وسيلة قلق دائم ومبلور أخلاقا ومقدما لعطاء وهو تفاصله المشاهد بكل ما يدور من حوله.
ص182.
لقد دعا بريشت إلى تطوير فنين: “فن التمثيل” و“فن المشاهدة“، ففي مسرحه الملحمي الذي بلوره في نهاية العشرينات، عمد بريشت إلى “التغريب” تغريب العمل المسرحي، ليتخذ موقفا نقديا وإيجابيا من قبل الممثلين والمشاهدين.
فهدف “التغريب” هو تمكين المشاهد من ممارسة النقد المثمر وفق موقف اجتماعي، ولكي يتوفر التغريب كما يقول بريشت: “يجب على الممثل أن يرفض الوسائل التي يمثلها الممثل، وعلى الممثل في هذه الحالة ألا يقع هو كذلك في غيبوبة الشخصية التي يقوم بتمثيلها“.
والتغريب لا يثير النقد الإيجابي في ذهن ونفس المشاهد إلا عن طريق دقة الملاحظة والإتقان العالي، عند ذاك فقط يتحول التغريب إلى عملية غنية وإلى ينبوع للسرور، فالتعليم في المسرح ممكن حيث تكون التسلية ممكنة.
خطوات مع هيلينا غايكل – التجربة المسرحية معايشة وانعكاسات “يوسف العاني” دار الفرابي – بيروت 1979.
ص182.
يقول يوسف العاني: “وعندي أن الدور الاجتماعي للمسرح لا يمكن أن يترك أثره وبصماته العميقة الصائبة إن لم يكن هذا المسرح سياسيا يشخص الداء، ويحدد مناطق الأمراض ومسبباتها ويربط بين سلوك الحاكم والمحكوم بل ويساهم في التغيير الاجتماعي والسياسي نحو الأحسن والأنفع والأكثر تقدمية والأسرع لحاقا بركب الحضارة الراكض إلى الأمام“.
خطوات مع هيلينا غايكل – التجربة المسرحية معايشة وانعكاسات “يوسف العاني” دار الفرابي – بيروت 1979.
ص26.
يقول عبد الكريم برشيد: “إن المسرح العربي قد ولد يوم ولد المجتمع العربي، هذا الوليد لا يشبه إلا ذاته، لأنه في تركيبه مخالف للمسرح ايوناني الغربي، وهذا شيء طبيعي ما دام أنه مرتبط بشروط جغرافية وتاريخية واجتماعية وذهنية ونفسية مختلفة“.
وقضية المسرح السياسي فيه التباس المصطلح ومجانبة الفكرة.
ولقد كان المسرح السياسي عند كل من أوروين بيسكاتور وبرتولد بريخت، استجابة تلقائية من رجل المسرح لأحداث التي مهدت للحرب الثانية.
بدأت الحركة المسرحية في مصر وفي بلدان أخرى من العالم العربي وخاصة في سوريا ولبنان، تظهر اهتماما ملحوظا بما يسمى بالمسرح السياسي.
والواقع أن هذه التسمية، وإن كانت جديدة علينا، إلا أنها ليست جديدة على المسرح العالمي وخاصة في الدول التي سبق فيها ظهوره الفكر الاشتراكي، ولست هنا بصدد الحديث عن تاريخ المسرح السياسي، لكن المهم أننا بدأنا نهتم به بشكل واضح مع منتصف الستينات بعد أن بدأت المفاهيم الاشتراكية التي غرست بدورها في مطلع العقد المذكور تمد لها جذورا، ثم جاءت نكسة الخامس من يونيو فعمقت إحساس الفنان العربي بمسؤوليته تجاه جمهوره وتجاه نفسه.
ص أ.
ماذا يقصد بالمسرح السياسي؟ في رأيي أن “المسرحية السياسية” بمفهومها الحقيقي هي استخدام خشبة المسرح لتصوير جوانب مشكلة محددة غالبا ما تكون سياسية، وقد تكون اقتصادية، مع تقديم وجهة نظر محددة بغية التأثير في الجمهور أو تعليمه بطريقة فنية تعتمد على كل أدوات التعبير التي تميز المسرح عن كل ضروب الفنون الأخرى.
ص أ – ب.
فالمسرح السياسي يهدف إلى إيقاظ الناس ثم تعليمهم، يعتمد إلى حد كبير على الحقائق أو القيمة الإخبارية للواقع، أي أن عملية الكتابة للمسرح السياسي هنا تسبقها مرحلة طويلة من البحث والتقصي.
ص ج.
فالمسرح السياسي لا يهتم بالفرد ولا يحاول تصوير شخصية، لأنه أساسا لا يحاول التعرض لمشكلة فردية، بل مشكلة جماعية، من هنا لا نرى البطل التقليدي أو غير التقليدي ولا نرى شخصيات ثابتة إلا في النادر، المهم هو تقديم الجماعة التي تمسها المشكلة وحينما تحل المشكلة فإن الحل لا يجيء نتيجة حتمية فنية أو نتيجة منطق التسلسل الفني، بل يجيء هذا الحل على أنه الحل الذي حدث فعلا أو الذي يجب أن يحدث في الواقع.
ص ه – و.
يقول هالى فلاناجان: “كان مفهومنا عن المسرح أنه لا يجب أن يقوم على عدد قليل من المسرحيات يقدم في عدد قليل من المدن، ليشاهده عدد قليل من الناس، ولكنه يجب أن يدخل في دائرته بصورة متزايدة، عن طريق الموضوع المباشر، وعن طريق المشاركة الفعلية أحيانا، سكان المنطقة أنفسهم“.
ص5.
ويمضي توماس ديكنسون موضحا هذا الاتجاه الجديد قائلا: “يجب علينا الآن أن ننظر إلى المسرح، لا بمثابة أداة لترفيه الشعب، بل كأداة لتعبئة إرادتهم لخدمة قضية محددة، ولا يحدد الفنان المبدع نوع هذه القضية بل يحددها أيضا الفكر السياسي للعصر نفسه، وهنا يظهر إذن أول تأثير تتركه الثورة الاجتماعية على الفن، إنها تنقل مركز الحساسية من الفنان إلى الإرادة السياسية، والقاعدة أن المسرح يخدم هذه العملية بإحدى طريقتين: أولا: بالنقد العنيف لكل أشكال النظام القائم وأخلاقياته وأنظمته ومذاهبه الفكرية، ثانيا: بنشر مبادئ الجماعة الجديدة الهاجمة إلى أن تتحقق أهدافها“.
الشكل الملحمي كان أكثر قدرة على التعبير عن الحقائق المعاصرة وذلك بسبب إمكانيات السرد التي يوفرها هذا الشكل للمؤلف الدرامي، يقول أرسطو: “إن هذا يرجع إلى أنه في حالة التراجيديا ليس من الممكن تصوير أجزاء مختلفة من الحدث ابتداء من وقت عرضها، بل تقديم الجزء الذي نراه على المسرح فقط، والذي يشمل الممثلين، أما فيما يتعلق بالملحمة فمن الممكن، بسبب طبيعتها القصصية فإن من الممكن تقديم أجزاء متعددة بين الحدث ابتداء من وقت حدوثها، وإذا كانت هذه الأجزاء متعارضة فإنها تعمق الأثر الكلي للقصيدة، من هنا تمتاز الملحمة بهذه الخصيصة، وهي خصيصة التنويع، بمعنى تقديم أجزاء متنوعة“.
ص69.
إن هدف المسرح الملحمي كان تقديم مظهر الحقيقة الاجتماعية، أن عملية عرض طريقة سير الأشياء تقوم بفك الكل إلى أجزاء بدلا من مجرد تصوير الشيء ككل، ومما لاشك فيه أن الشكل الملحمي أكثر الأشكال المسرحية نجاحا في تحطيم أي إيهام بالواقع، وعن طريق السرد فقط يمكن ربط هذه الفقرات المنفصلة في شكل درامي، ونتيجة لذلك فإن الخصائص المميزة للشكل الملحمي هي مجموعة الأحداث المنفصلة والأغاني الجماعية وعنصر السرد والمحاضرات المباشرة.
ص70.
في المسرح العربي مرس تزييف متعمد لمفهوم الثورة، أحيانا استخدم المصطلح السياسي بوصفه مصطلحا فنيا، وأحيانا أخرى عمم المفهوم الفني على أنه يحمل قيمة سياسية مباشرة، حدث هذا نتيجة لأسباب متعددة، أهمها أن كثيرا من كتاب المسرح العرب لجأوا إلى كلمات شعارية طنانة وضمنوها مسرحياتهم، وذلك عن كامل قصد وتخطيط للترويج لأعمالهم أمام حكومات تشغلها السياسة اليومية، ومثقفين منهمكين في تصنيف الكتاب وإلصاق “الإتيكات” على ظهورهم، ووسط شارع مسيس تعميه الأباطيل ويحلم بالأبطال.
ص132.
إن نهضة المسرح العربي في بعض أقطاره لا علاقة لها بشكل النظام السياسي، فالمسرح في المغرب ناهض ومتقدم رغم أن النظام ملكي، وهذه الحالة ليست وحيدة أو نادرة، بل نجد أمثلة كثيرة على بلدان ذات أنظمة اشتراكية أو شبه اشتراكية أعاقت تقدم المسرح واعتبرته وسيلة إعلام ودعاية، كما أن هناك بالمقابل أنظمة غير اشتراكية لم تسمح للمسرح بالتطور والازدهار، ولكن لنكن موضوعيين في نظرتنا إلى النتاج المسرحي العربي، إن المسرحيات الوطنية ضد الاستعمار لم تجسد فلسفة ثورية مطلقة ولم تجترح خطا جديدا من الإبداع، بل كانت ذات وظيفة مرحلية راهنة، والمسرحيات الاجتماعية لم تكن مسرحيات تغيير، ولم تتجاوز الواقعية الفوتوغرافية مع بعض تأثيرات الميلودراما، أما المسرح السياسي العربي إذا صحت التسمية فمن الغريب أن نجده قد نشأ في أحضان أنظمة توتاليتارية، ودرج في مسارحها الرسمية، وانتظم في صفوفه من هم في يسار اليسار ووسط اليسار وبعض المحافظين ذوي الجذور الدينية والأخلاقية التقليدية، وهو مسرح غير أصيل، بمعنى أنه مقلد بتلفيقية بارعة لإنجازات مسرحيين أوروبيين مع بعض البهارات العربية التاريخية والتراثية.
ص133 – 134.
أي من تيارات المسرح العربي المعاصر يمثل الثورة أكثر من غيره؟ وهل لليافطات التي يرفعها كتاب المسرح العرب مصداقية حقيقية، أم أنها مجرد شعارات؟
لا توجد أجوبة مسبقة، فالنقد عملية تفسير وتحليل لأعمال إبداعية، بأكبر قدر من الموضوعية والنزاهة والتجرد، ولكن النتيجة التي يسهل استخلاصها عبر دراستنا لحركة المسرح العربي خلال اثنتي عشرة سنة هي أن المسرح الثوري نادر التواجد، وأنه ظهر أحيانا في طفرات سواء على صعيد التأليف أم على صعيد الإخراج المسرحي والتمثيل، لكن الاستمرار طول العمر لم يكتب له، خاصة مع انتهاء الظروف السياسية الخصبة التي ساعدت على نشوئه هنا أو هناك، إن نتاج الوطن العربي من المسرح الثوري قد يبدو مشرفا وهو كذلك بالفعل من حيث القيمة، ولكن عقبات كثيرة من الجمهور ومن السلطات اعترضت وتعترض سبيله، كما تنتصب الحواجز الإقليمية، واللهجات المحلية، وندرة الاتصال الثقافي بين المشرق والمغرب، عوائق من نوع آخر.
إن المسرح الثوري لابد أن يحقق ثلاثة شروط أساسية، كي يستحق هذه التسمية، وبفقدان واحد منها يمكن أن يطلق عليه أي اسم آخر، مثل “مسرح التمرد” أو “مسرح التسييس” أو “المسرح التعليمي” أو “المسرح التجريبي” أو “مختبر المسرح“…الخ
فليس في هذا غضاضة من شأنه، والشروط الثلاثة هي:
- حداثة الشكل المسرحي وابتعاده عن تقليد نمط قديم ثابت، تلك مسألة متعلقة بالعرض.
- تقدمية المضمون من حيث تعبيره بصدق عن النوازع والآمال القومية والإنسانية معا، ومعالجة إحباطات الواقع بجرأة وصراحة، سواء كان زمان العمل ومكانه راهنين أو تاريخيين.
- الاتصال بجمهور مسرحي عريض من جميع المستويات، وعدم الاقتصار على فئة اجتماعية معينة أو على نخبة قليلة مثقفة.
ص135 – 136.
لاشك الآن أننا سنذكر من الكتاب المسرحيين الذين قاربوا المسرحية الثورية في بعض كتاباتهم: ألفريد فرج – محمود دياب – ميخائيل رومان – نجيب سرور – صلاح عبد الصبور ويسري الجندي من مصر العربية، ولاشك أننا سنذكر: أحمد الطيب العلج، وعبد الكريم برشيد من المغرب، وعصام محفوظ، وجلال خوري، وإدوار أمين البستاني من لبنان، وعز الدين المدني من تونس، ويوسف العاني وقاسم محمد وعادل كاظم من العراق، وجمال أبو حمدان من الأردن، وسعد الله ونوس وممدوح عدوان ومحمد الماغوط ووليد إخلاصي ورياض عصمت من سوريا.
ص136.
نخلص إلى أنه من الصعب بالنسبة لأقطار الوطن العربي الربط حتميا بين الأنظمة السياسية التي تدعي الثورة وبين تقدم المسرح، من المؤكد فقط أن الأقطار التي تهيمن عليها العصبية الدينية الناسبة نفسها إلى الإسلام تعاني من تخلف المسرح فيها، أما في باقي الأقطار فإننا نلاحظ أن المسرح يزدهر في الأقطار التي تتمتع بأكبر قدر من الديمقراطية، فهو مزدهر في المغرب وتونس، كما أنه مزدهرا خلال نهضة مصر، بأن عهد عبد الناصر في حين أنه تراجع تراجعا سريع في زمن الانفتاح الديمقراطي الزائف.
ص137.
للأسف نقول: إن المسرح العربي يعاني مخاضا عسيرا، ويمر بمخاطر صعبة، إنه يواجه طغيان التجارة في الفن، عبر السينما والتلفزيون خاصة، ويجد ازدهاره واتصاله الواسع بالناس من خلال مسرحيات كوميدية خفيفة تخلو في الغالب تماما من أي فن، إلا فن التهريج اللفظي، معتمدة على رصيد النجوم والقفشات السياسية السطحية لا أكثر، بالمقابل، نجد أن ما حظي بفرص العرض من أعمال الكتاب المسرحيين العرب محدود، بنسب متفاوتة بين قطر وآخر، ولكن الكاتب العربي يواجه دائما قلقا مستديما حول احتمال عدم إنتاج عمله، بغض النظر عن جودة العمل ومكانة المؤلف.
إن هدف المسرح هو الإمتاع والتنوير، وقد تتعدد وتتناقض التعريفات، وقد يضيف قائل بأن هدفه هو التنوير، ولكنني أجد عملية التغيير التي يحرض المسرح عليها بطيئة وغير مباشرة، فالمسرح ليس سلاحا انقلابيا، وهو نادرا ما يؤدي حتى إلى مظاهرة، إنه تفاعل بين إنسانين: فنان ومتخرج، يستمد واقعه من الواقع، ولكنه لا يقتدي به بالضرورة، بل كثيرا ما يعمل على خلق حياة فنية رديفة له، بحيث تنير أحاسيسنا وعقولنا، بعاطفة شاعرية، أو بتفكير تأملي، أو بصدمة قاسية، إن المسرح الذي يسهم في تغيير المجتمع حقا ليس مسرح الاستعراض السياسي والشعارات الدعائية الصارخة، وإنما هو المسرح الإنساني الواقعي الشاعري المتمرد، وهو بالبداهة مسرح لا يكتفي بأن يكون جميلا ومسليا، وإنما ينغرس في قلب الأحداث، وينبت شامخا من تربة بيئته وزمانه، إنه ليس مسرحا على الهامش، ولكنه مسرح لا ينسى طموحاته بأن يكون جماليا وممتعا.
ص138 – 139.
إن المسرح العربي الثوري ما زال طموحا وحلما تحبطه كثير من العقبات، ولكن الأمل قائم رغم كل التراجعات والحدود لأن هناك أعمالا مشرقة وثورية وعظيمة، ظهرت من قبل في سوريا ومصر والعراق ولبنان والمغرب وتونس والكويت والجزائر، مهما كانت قليلة… وماضية.
ص140.
أكد الدكتور رفيق الصبان: “أن المسرح أداة سياسية بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يجد مسوغا لوجوده إذا ابتعد عن معالجة القضايا السياسية والاقتصادية النابعة من العصر“، ومثله فعل خليل هنداوي فقد قال بعبارة واضحة: “وفي الوقت ذلته، لا ينبغي لنا أن ننسى أننا لم نخلق بعد الكاتب المسرحي اللائق، الواعي، المدرك لمسؤوليته الفنية في إبداع الحياة، وتطوير النضال الفكري الثوري، وفهم المجتمع فهما صحيحا، وجعله الينبوع الوحيد لكل فن“.
فتمة صلة قوية “بين الأدب المسرحي والسياسة، فهي في داخله في تكوينه ملتصقة به، وهو ملتحم فيها لا ملحق بها لا مجال للفصل بينهما، وحدتهما الحياة التي ينتميان إليها، ويشكلان خلاصة من أهم خلاصاتها“.
وتلكم هي فحوى دراسة على عقلق عرسان “سياسة في المسرح“، التمييز بين المسرح وفي المسرح.
ص54 – 55.
إن علي عقله عرسان يقول بصريح العبارة: “إن نغمة المسرح السياسي التي نسمعها تعني شيئا آخر غير المسرح… وينبغي أن تلبس لبوس الفن والثقافة وهي إلى الدعاية والإعلام المروج لا تجاه أقرب منها إلى الفن والثقافة، وإلا متى كان المسرح غريبا عن السياسة منفصلا عنها، حتى يأتي أنبياء العصر ويرأبوا الصدع الثقافي الخطير الذي حصل في تراث الإنسانية الحضاري؟!”.
ص55 – 56.
المسرح والسياسة علاقة قائمة ولا تحتاج إلى برهان، ولأن كتابات واكبتها ممارسات بعد حين وكان لها دور التهويل والتهويش، فإن كتاب “سياسة في المسرح” هو نوع من تصفية الحساب مع نزعة إلغاء الحدود بين الفكر والفن من جهة، وبين الفن والمشهدية المسرحية من جهة أخرى.
ص56.
وهذا يعني أن نقد مصطلح المسرح السياسي يرتكز إلى مغالطة المفهوم الذي شاع في الممارسة وكانت له نتائج سلبية وعميقة، فالمسرح السياسي كما هو واضح، يضج بالكلمات القادحة شرا خاطفا نحو مظاهر يومية بقصد تعميمها، وليس مسرح الفعل السياسي وقد تغلغل في نسيج الحياة.
ص57.
ولعل المسرح السياسي، هو اللون الذي ميز الاتجاه المسرحي، خصوصا بعد نكسة يونيو 1967، لأن السياسة في الواقع، ليست إلا موضوعا كغيره من الموضوعات بالنسبة للفن، فالأفكار في المسرح السياسي لابد أن تستمد من الواقع، أو أن تحاول الاتجاه إليه حيث يحافظ المسرحي المثقف على الارتباط المباشر بين مشاعره وبين الواقع، فالمسرح السياسي كفن ثوري، قادر على تغيير الحياة وحين يفقد الفن قدرته يفقد هدفه، فالمسرح يطرح المشكلة المعالجة بشكل ماشر ومكثف في فترة زمنية محددة.
ص46 – 47.
ونعتقد أنه ليس ثمة ضرورة للمسرح السياسي عموما، وإن كنا جميعا نتمنى ألا تكون هناك سلبيات في الوطن العربي، سواء من السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والديمقراطية يمارسها الجميع كاملة، عندئذ سيكف المسرح السياسي عن عرض مواطن الضعف لأن المسرح سيكون وقتها متجها إلى التجريب والتجديد، وهذا غير وارد على الإطلاق في عالمنا الثالث، ووطننا العربي، لأن غياب الناس عن الحالة السياسية، يؤدي إلى كارثة، وقد أدى بالفعل إلى كارثة يونيو 1967، لأن المسرح يعمل على حضور الناس حضورا واعيا ودائما ومنظما، كما يرى مصطفى الحلاج، وتدخلهم في شؤونهم العامة أمر سياسي لمنع احتمال وجود طغيان في أجهزة السلطة، بالإضافة إلى نوازع الملكية، وتفشيها في الطبقة الحاكمة ومن هنا كان الحضور الواعي المنظم الذي يمارسه المسرح السياسي ضرورة لأنه يتحرك مع حركة الحياة ومعركة التاريخ، ويصبح منبرا للدعوة ومنطلقا للعمل الثوري الذي يستهدف التغيير نحو الأفضل، فعلى منصة المسرح السياسي تتنوع القضايا والمعارك، قضايا الإنسان المعاصر ومعاركه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحرب والسلام واستلاب الإنسان.