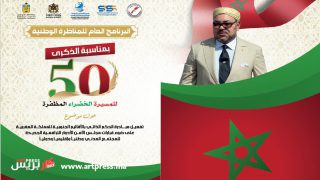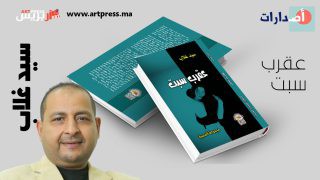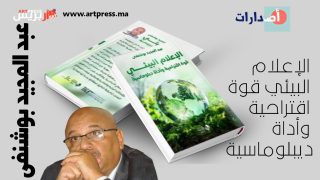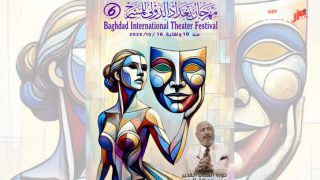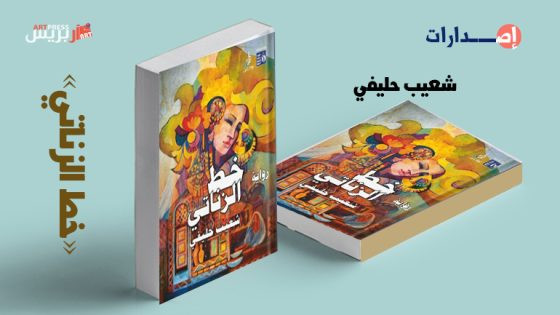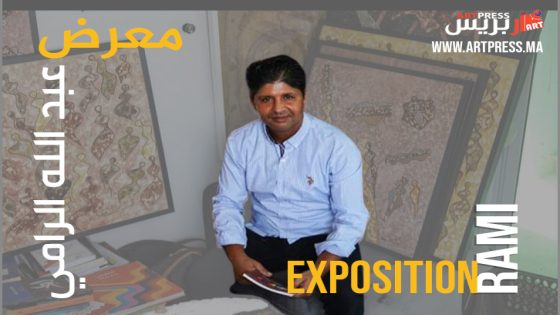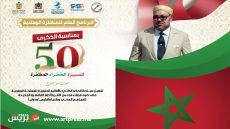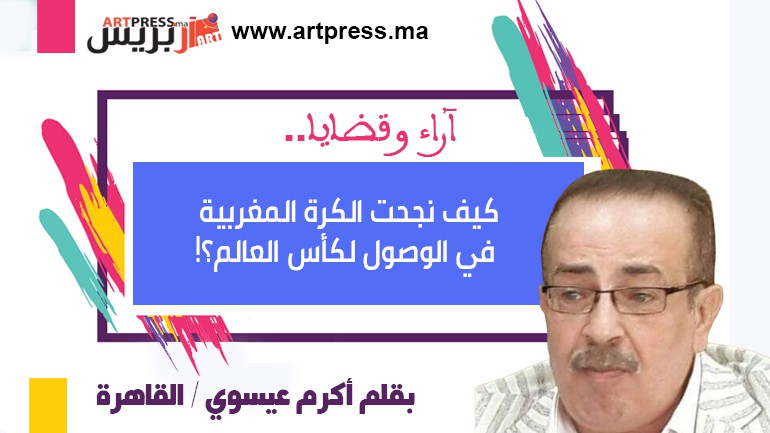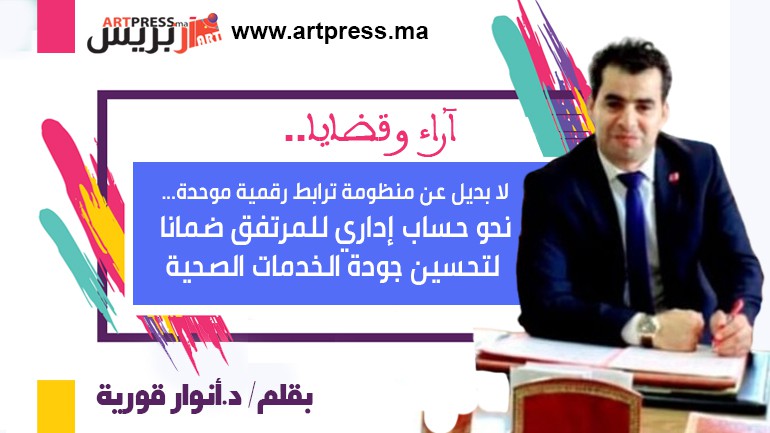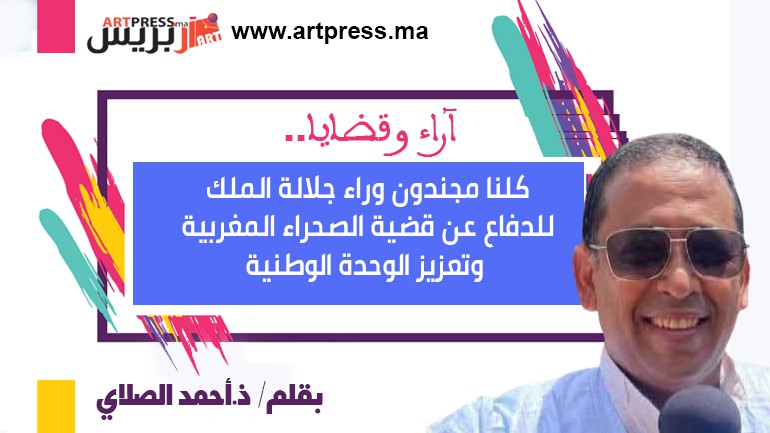كَيْ يَتَعَلَّمَ قَلْبِيَ الحَيَاةَ: كُلَّ يَوْم سآتِيكُم بنَصّ بورتري.
حسن بيريش
(1)
كي أكتب عن ماجدة داغر،
لا تكفيني نداوة حبر،
بل يلزمني عنفوان جنون !
في حضرة هذه المتمردة على شرائع المعنى، والمحدقة في أعالي الانخفاض، لا أحتاج إلى جموح كلام، بل إلى جنوح ريح. بداية التنزيل تخيف توثب يدي، ونهاية العد تحد من خطو قلبي. وها أنا ممدد على سرير المعنى، لا أنا قادر على اقتراف عبارة تدنيني منها، ولا هي قريبة كي تخيط قماشا أرتديه لأعري ارتباك ستري.
متأخرا عن عمري بسيل حبر، أكتبني، قطعا، لأقراها، وصلا، وما بينهما، تراني، هي، من مسافة وثوقها، وألمحها، أنا، من محبرة عثاري. وإلى سفوري أمشي لا أتوكأ إلا على رغائبي المتعالقة مع وشاح نصها، وفي حجبها تبقى متزملة بشعاع ليل في فلوات ضوئه أكتب ولعي.
“أُشارف صوتك العالق كنصفي الآخر
في هديري
في غديرك المسكون
بالعطش”.
(2)
ما هي بشاعرة، بل هي أرخبيل قصيد ممتد من ماء الجملة إلى ريح الصورة. من شطحات المجاز حتى جنون الحواس. ومن ليالي المضمر إلى نهارات التجلي. ثم روّضت مستحيل ممكنها، وفتحت “قفيرا في الجسد المقصول”، وقادت بلاغة مكرها إلى “الأهداب العائمة” في “الوجه المائي”.
تخطيها لعلو انخفاض رؤيتها، هو تجاور لارتفاع جذرها في خضراء الكلم. إنه الرمز اللولبي من يأخذ ماجدة إلى منحى غرائبي يمتطي صهوات “منفى الذاكرة الآتية”.
“مدّني سريراً لأحزانك
ومِظلةً في فيء عينيك
تتلو أغنية الرحيل
كلما ظنَّ المطر
أن حزنك الصغير
يكبر في بال غيمة”.
كم كانت وارفة المعنى، غزيرة الفيء، لما أكدت في حوارها، الممتد من الصحو إلى الغيم، مع إسماعيل فقيه:
“القصيدة تبكي قبلنا
وتضحك قبلنا
وتتألم لوجعنا الآتي”.
(3)
“نقطة ويكتمل النهر
ويجري الغدير
في أضلعِك”.
في مهب ٱيات الحواس كبر وعي عبارتها، تنامت أفياء جسد نصها، انتقلت من ٱيل إلى البصر إلى ٱيل إلى البصيرة. ثم لا نجاة لها، لا اطمئنان لنا، من طوفان الاستعارة، إلا في إغراق سفينة التشبيه.
“ضيقة كانت الممرات
وسيد الباب الملتهب
يسنُّ انتظاره
على بعد غيمتين
من الخطوات المتعثرة
ويشحذ سِنَّه الوحيدة
لوليمة الأرواح الناضجة
على نار مُغرية”.
تحديقها في الانخفاض رؤية في الأعالي. هكذا أصف ثراء معجمها اللغوي، وهي تطوح بي نحو حقولها الدلالية، ذات العجب، وتأسرني بصورها البكر اللعوب. أما وحي الإشارة، وتمرد الرمز، وفوران التجسيم، فاقرأ ولا تسل.
أليس وجيبها من داهمني، ذات حواس، وهمس لي بجلبة: “قصائدي مائدة متهدجة” ؟! أليس ولعي من أعلن، خلال سحب صبوات ماطرة: أخاطب فيك الكلمة لتصير قبضة، خطوة، وجناحا ؟!
“في طريق العودةِ
تطيلُ التحديقَ في أشيائي المتساقطة
لئلّا تلامس الأرض،
وفي نظرتِك المأهولة
بيوتُ عناكب وتَناصُّ قصائد.
وهي تغنّي،
تقفُ السناجبُ الجائعة
على ناصيةِ القصيدة
تلتهمُ الشطورَ المتخمةَ بك
وتتركُ ليَ الأفعالَ الناقصة رغيفاً”.
(4)
تلفت ماجدة جماع انتباهي حين تقارب الجسد من حواسه الموغلة في غموض الوضوح. حين تسوره بتجليات شفيفة تنشق عما تحتها، عبر تكليم صمته الجهير، والدفع به صوب الإفصاح عن تمثلاته، نحو ولوج رحيب غوايته.
“لا تنأي بشهواتِك عن الثمار المحرّمة،
كوني التفاحةَ
واقضِمي شهواتِ العالم”.
حتى وهي في مهب مهاوي الجسد، تأبى متون رمزيتها أن تؤول إلى إملاق في الإشارة. إنها تتبدى، إبان كل تطلع إلى حلم القصيدة، وقصيدة الحلم، حبلى بنصوص تتشكل في رحم الجسد الأنثوي، وتعثر على خصوبتها في جسد الٱخر، الرجل، هذا الذي يبادلها لعبة المفرد / المتعدد.
“بين مُنخَفضِ الرُّهابِ وأَعالِيك
زمنٌ يتمدّدُ كحِممٍ ملتهبة
وأذرعٌ مهدورةُ العناق،
وأنا أعيدُ ارتداءك عند عودةِ كلِّ خريف”.
إنها مهارة رؤية غور التشابه في ثراء الاختلاف، تلك التي تتقنها الشاعرة، وتمشي بها صوب منتهى دلالتها، فلا يبقى إغواء الجسد مرهونا بالمؤنث وحده.
(5)
“الشعر لا يحتاج إلى أظافر مطلية
أو إلى أصابع خشنة
لكي يبرهن قدراته،
بشعر طويل أو قصير،
المهم أن تولد القصيدة،
تلك هي البراعة”.
النص أعمق من اليد التي تكتبه. إنه متمرد لا يأبه بتقسيم يؤول به نحو “هرطقة لغوية”. منحاز هو إلى أقاصيه حيث يبرق ويرعد في منأى عن تجنيس سمائه. وأي سعي يروم وضعه / حبسه في قفص، مٱله تفاقم التحليق.
لهذا، تسخر ماجدة من الافتعال الذكوري، الذي يسعى إلى تشريح جسد النص، بغية البحث المضمر في شكل عضوه التناسلي، تمهيدا لاعتقاله في حيز جنسي.
“امرأة متشّحةٌ بالنساءِ والأراجيز
يعانقُ خَطوَها غسقُ المنام،
تجرُّ سُبحتَها المتصلةَ بتضرعاتِ فينوس
لتنامَ في المَحارة قبل هبوطِ الذاكرة”.
(6)
“ولا ابتداء
إلّا هو”.
تجهر ماجدة داغر، كي تقود الهنيهة المتقدة باتجاه اللعب الدلالي الحر بثنائية هي / هو. بيد أن التلقي، الذي ينضح برهافة الخبء، سرعان ما يدرك أن في شسوع الاستمرار يكمن وجوب البدء.
“للشرفة المستترة
وجوباً تقديرها أنتِ”.