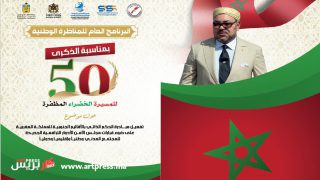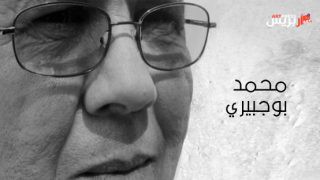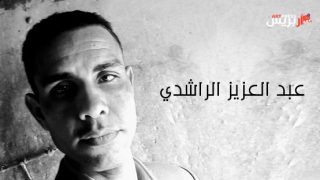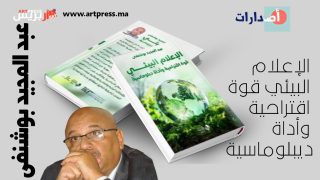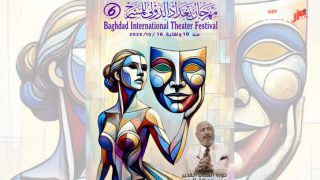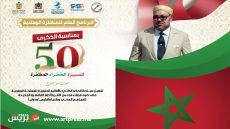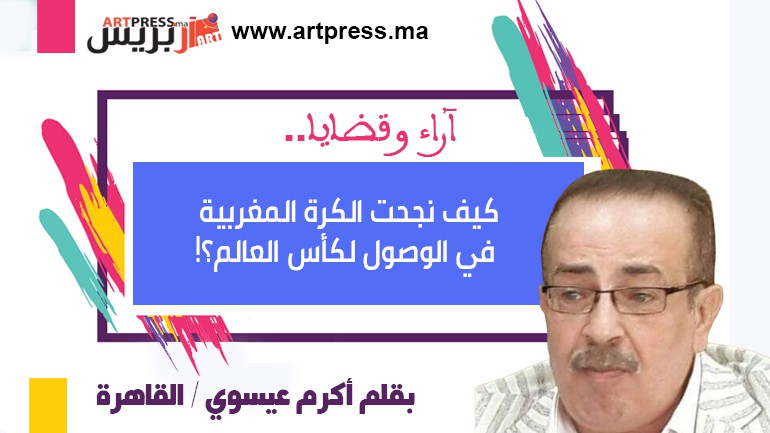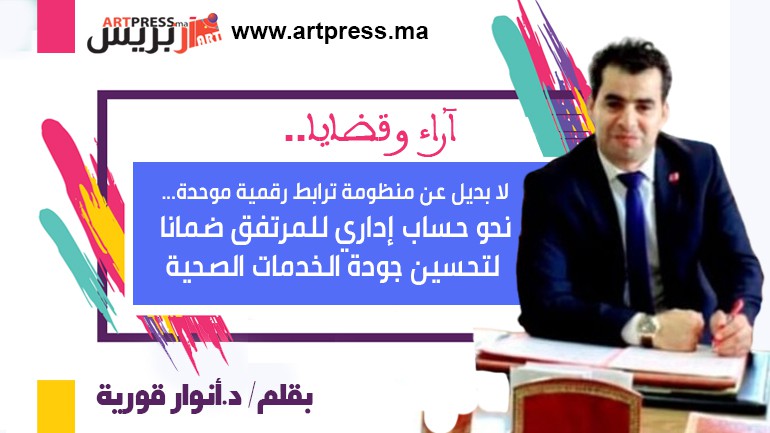نص الحوار الذي أجراه الأستاذ الدكتور هشام الحليمي مع الدكتورة كريمة نور عيساوي في برنامجه قضايا فكرية على القناة السادسة عنوان الحلقة: فرص الحوار الحضاري في تحقيق التقارب البناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية.
حوار الدكتور هشام الحليمي
1- ما هو السياق التاريخي الذي أسهم في نشأة وتبلور مفهوم حوار الحضارات؟
* يُعتبر الحوار من المفاهيم الحديثة التداول في الأدب السياسي والثقافي. أما مصطلح حوار الحضارات فهو الابن الشرعي لحقبة القرن العشرين، ولم يعرف نشاطا متزايدا في الاستعمال إلا منذ تسعينيات القرن الماضي. فهو محصلة عوامل كثيرة منها نهاية الصراع الإيديولوجي الذي أعقب سقوط المعسكر الشرقي / الاشتراكي، وصعود دور الأديان في المجتمعات المعاصرة. وهو ما كان قد تنبه إليه الفيلسوف الفرنسي اندريه مالرو حينما وسم في ثمانينيات القرن الماضي، وفي عز الفكر العلماني، وفي أوج ازدهار المذاهب الاشتراكية القرن الذي نعيش فيه الآن، القرن الواحد والعشرين، بعصر الأديان. ثم الطفرة النوعية التي شهدتها وسائل الإعلام والتواصل. و لا ينبغي أن ننسى مقولة “صدام الحضارات” التي أطلقها هنتغتون وردود الفعل الكثيرة التي ترتبت عنها. هذا هو بشكل عام السياق التاريخي الذي أسهم في نشأة وتبلور مفهوم حوار الحضارات.
2- كيف تفاعلت المنظمات الدولية مع مفهوم حوار الحضارات بعد أن صار حديث الأوساط العلمية والثقافية والسياسية؟
* على مستوى المنظمات الدولية أعتقد أنه ليس صدفة أن تعلن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001 سنة للحوار بين الحضارات. فالحوار بين الحضارات المعاصرة بالنسبة إليها هو المخرج الوحيد المتاح أمام البشرية للتعاون المشترك من أجل إيجاد نظام عالمي جديد يستند إلى القيم الأخلاقية العليا المشتركة فيما بينها. إن حوار الحضارات ليس ترفا فكريا أو خيارا فرديا، فهو يعبر عن حاجة إنسانية ملحة ومستعجلة تتطلبها التحولات التي يشهدها العالم في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من تاريخ البشرية، خاصة في ظل اتساع رقعة التوتر واندلاع النزاعات الأيديولوجية وتزايد مخاطر الفكر الاستئصالي. فالحوار بين الحضارات خيار استراتيجي. وهو السبيل الأوحد لمواجهة كل أشكال الإقصاء وكل أنواع الإرهاب، ولمقاومة خطاب الكراهية الذي بدأ يستشري كالنار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي.
3- من المفارقات أن الحديث المتزايد عن حوار الحضارات والأديان اقترن بتفشي ظاهرة الإرهاب. والمؤسف أن تكون لبعض الجماعات الإسلامية المتطرفة يد في ذلك. غير أن هذا لا يعفي في المقابل دور الإعلام الغربي في تشويه صورة الإسلام. ما رأيك في هذا الاستنتاج؟
* من سوء حظنا نحن العرب والمسلمين أننا أصبحنا في موقع المتهم الذي ألصقت به دون تحر أو تثبت تُهم هو بريء منها. فوقع الخلط المقصود بين الإسلام دين التسامح الحق كما يُمثله غالبية المسلمين وبعض الجماعات الدينية المتطرفة التي لا تمثل إلا نفسها. هو خلط مقصود وأضع خطا أحمر تحت “مقصود” لأنه يعكس بعض أوجه الصراع القديم بين الغرب والإسلام. فبمجرد الإعلان عن وقوع حدث إرهابي وحتى قبل التأكد من هوية فاعليه يُسارع الإعلام الغربي إلى نسبة الفعل الإجرامي إلى شخص له ملامح شرق أوسطية أو مغاربية أو ما شابه ذلك، وتتعالى أصوات الخبراء الذين يبحثون في ماضي تاريخ الإسلام عن قرائن تؤكد تجذر العنف في الشخصية الإسلامية، وتُزين أغلفة كبريات المجلات صور الدم واللحي والسيوف والمصاحف. أما إذا كان الفاعل غربيا فيتم التستر عن الحدث، و لا يحظى إلا بتغطية إعلامية متواضعة. وكثيرا ما يتم الترويج بأن المجرم مختل عقليا لإعفائه تماما من المسؤولية الجنائية. غير أن واقعة أسكتلندا خلطت الأوراق. فالإرهابي المسيحي لم يترك للإعلام الغربي أي فرصة مهما كانت صغيرة لقلب الحقائق أو تبريرها. وقد تابعنا جميعا وبالتفصيل الممل كيف حضر لعمله الإرهابي، وكيف حرص على تصويره. ما يُستفاد من هذه الواقعة أو غيرها أن الإرهاب لا دين له.
4- بما أنك استحضرت صورة الخبراء الغربيين الذين يبحثون في ماضي تاريخ الإسلام عن قرائن تؤكد تجذر العنف في الشخصية الإسلامية ألا يمكن القول أن الوجه الجميل للغرب كواحة للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان كما يسوق ذلك الإعلام الغربي بكل أنواعه يخفي تاريخا من التشوهات والانحرافات؟
* لنتذكر معاناة مسيحيي الشرق مع الإمبراطورية الرومانية وكيف وجدوا في الفتوحات الإسلامية مبررا لفك الارتباط بها على الرغم من اشتراكهم في الانتماء إلى الديانة المسيحية . مع استثناء الملكانيين. فقد استُقبل الفاتحون المسلمون كمحررين خلصوا المدن والقرى من النظام البيزنطي المكروه حسب تعبير الأب يواكيم مبارك . -لنتذكر الحروب الصليبية : بمجرد دخول الجيوش الصليبية بيت المقدس ارتكبوا فيها أبشع المذابح. -كذلك محاكم التفتيش التي كانت مهمتها تتمثل في تفتيش كل بيت وكل متجر بحثا عن الهراطقة قصد إذاقتهم أقسى أنواع التعذيب. -حرب الاسترداد وما ترتب عنها من إرغام المسلمين على التنصير، وحرق المصاحف، ومنع التحدث بالعربية.
– وابادة الهنود الحمر والحروب الدينية والاستعمار ونهب الثروات والحرب العالمية الأولى والثانية. ما حدث هو تغييب هذه الصورة البشعة و اعتبار ما يسمى بالارهاب الإسلامي امتدادا طبيعيا لحضارة عربية إسلامية قامت في الماضي على العنف.
5- ما السبيل إذن لخلق فرص حقيقية للحوار الحضاري الذي يمكن أن يفضي إلى تحقيق التقارب البناء بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية؟
* لا يمكن أن ننكر بجرة قلم سوء التفاهم الذي ساد على امتداد قرون من الزمن، العلاقة بين الإسلام والغرب المسيحي. فظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية وانتشاره على حساب المسيحية في الشام والعراق ومصر وبلاد فارس وآسيا الصغرى وشمال أفريقيا والأندلس لم يكن ليَنظر إليه بعين الرضا في الغرب المسيحي. ولم تكن الحروب الصليبية إلا تعبيرا مباشرا عن هذا السخط وعن هذا التخوف المتزايد من هيمنة الإسلام. ولما اعيتهم الحيلة في المواجهة العسكرية، وفشلوا في تحقيق ما كانوا يتطلعون إليه رأوا أنه لا مناص من الدخول في معركة فكرية قوامها ترجمة القرآن الكريم ومحاولة التعرف على التراث الإسلامي. لقد خرج الأب بطرس المبجل رئيس دير كيلاني بقناعة بأن لا سبيل إلى مكافحة هرطقة محمد بعنف السلاح الأعمى وإنما بقوة الكلمة، ودحضها بروح المنطق الحكيم للمحبة ، لكن تحقيق هذا المطلب كان يشترط التعمق برأي الخصم أولا، وهكذا وضع خطة للعمل على ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية . بما أن الهدف لم يكن علميا فقد كان هذا التراث عرضة للتشويه والبتر. كما وجدوا ضالتهم في كتابات بعض مسيحيي الشرق أو غيرهم الموالين للغرب المسيحي الذين كانوا يكنون العداد للإسلام والمسلمين.
5- بما أن الإسلام في الغرب مُستهدف في ظل تصاعد نزعة الإسلاموفوبيا . ألا ترين أنه من الأجدر القيام بجملة من الخطوات الملموسة التي قد تعزز فرص التقارب بين الإسلام والغرب؟
* يجب أن نعترف بأننا مقصرين في التعريف بتراثنا العربي والإسلامي. ولاشك أن الكثيرين لا يعرفون بأنه تراث متنوع ومنفتح على ثقافات مختلفة، وأن الحوار بين أتباع الديانات السماوية وغيرها كان سمة أساسية فيه. يكفي أن نستحضر المناظرات الدينية التي كان يشارك فيها مسلمون ومسيحيون ويهود. وغالبا ما كانت تحظى برعاية ملكية أو أميرية. فقد تعددت المجالس أو المناظرات من قبيل: لقاء البطريرك السرياني يوحنا الأول (635-648) مع أمير جند حمص عمرو بن سعد، ولقاء البطريرك النسطوري طيموثاوس الأول (بطريرك من 780 إلى 823) والخليفة المهدي، ومجادلة إبراهيم الطبراني مع الأمير عبد الرحمن بن الأمير عبد الملك بن الصالح الهاشمي سنة 820م، ومجادلة أبي قرة مع المتكلمين المسلمين في حضرة المأمون، ومجالس مار ايليا مطران نصيبين (ت1049) مع الوزير أبي القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد المغربي.
كما أن انتماء المسيحيين واليهود إلى ما يسمى بالاقليات الدينية لم يحل دون انخراطهم في الجدل وفي الدفاع عن الديانات التي ينتسبون إليها . ولم يكن ارتباط البعض منهم بدواليب الحكم حائلا دون تأليفهم كتبا أو رسائل في دحض الدين الإسلامي أو في نقد القرآن الكريم. وأبرز مثال على ذلك أبو نوح الأنباري الذي ألف كتابا في دحض القرآن الكريم، على الرغم من أنه كان كاتبا لدى حاكم الموصل. الأمر الذي دفع العلماء المسلمين إلى الرد عليهم ومقارعة الحجة بالحجة. فكثرت المصنفات من قبيل الرد على النصارى أو الرد على اليهود. من ذلك أبو هذيل العلاف الذي رد على عمار البصري، والمردار الذي رد على (ت840م) على أبي قرة.
في سياق تاريخي يشجع على الحوار ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن كان من الطبيعي أن تشهد الحضارة العربية الإسلامية نشأة علم الأديان. المؤسف أن هذا الجزء من التراث يكاد أن يكون مغيبا وقد لا يصدق بعض الغربيين وجود إنتاج فكري وديني مسيحي مكتوب بالعربية. نتحمل قسطا من المسؤولية في إهماله وفي تقاعسنا عن التعريف به سواء على مستوى العالم العربي والإسلامي أو على المستوى الدولي. لقد شكل إسهام الأقليات الدينية في التراث العربي الإسلامي إبان العصور الوسطى علامة فارقة في تاريخ الحضارات الإنسانية. فالأمر لا يتعلق ها هنا ببضعة أفراد أو بجماعة بعينها أو بحالات معزولة، وإنما بانخراط كامل لهذه الأقليات، بغض النظر عن معتقداتها الدينية، في الكتابة وفي التأليف وفي المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. وقد تجسد ذلك أولا في تبنيهم للغة العربية، واتخاذها إما جزئيا أو كليا أداة لتحرير مصنفاتهم العلمية والفكرية والدينية، وتفاعلهم الدائم مع إنتاجها الثقافي والفكري.
6- على الرغم من أن العلاقة بين الحضارتين العربية والغربية عرفت الكثير من التعثرات والكبوات، غير أن ذلك لا ينبغي أن يخفي عن أعيننا وجود تفاعل بينهما. هل من أمثلة عن هذا التفاعل؟ وهل يمكن أن يكون جسرا نحو التفاهم ونحو التئام جروح الماضي؟
* نعم هذا صحيح فلا أحد يمكن أن ينكر أثر التراث اليوناني في نشأة بعض العلوم الإسلامية، ودور مسيحيي الشرق في ترجمته إلى العربية (حنين با إسحاق، إسحاق بن حنين، عيسى بن زرعة، يحيى بن عدي..). وفي الوقت نفسه لا أحد يستطيع أن يستهين بدور العلماء المسلمين في شرح وتفسير وتنقيح التراث اليوناني، واستفادة الحضارة الغربية من هذه الشروح. وهنا لا بد من الإشارة إلى دور اليهود في الأندلس الإسلامية في نقل التراث العربي والإسلامي إلى الغرب المسيحي. لقد ترجم اليهود حسب أحمد شحلان على مدى قرون، كتبا فلسفية وعلمية عربية إسلامية مشرقية ومغربية. ونذكر بعض أسماء المترجم لهم لنستدل بها على نوع النقول والامتداد الزمني الذي احتوته، وشساعة الحيز الجغرافي الذي جرت فيه وقائع هذه الترجمات. فمن بين المترجم لهم قسطا بن لوقا وثابت بن قرة واسحاق بن حنين وحنين بن إسحاق وأبو إسحاق البطروجي وأبو الحسن بن أبي الرجال والفرغاني وأبو إبراهيم بن يحيا الزرقلا وابن الهيثم والكندي والفارابي وابن سينا والرازي وأبو القاسم الزهراوي وإخوان الصفا وابن السيد البطليوسي وأبو القاسم أحمد بن السفار وأبو جعفر بن الأفلح الأشبيلي وابن باجة وابن طفيل والغزالي وابن رشد . وشكل ابن رشد محور أعمالهم إلى درجة أن الكثير من أصولها لم تصلنا باللغة العربية، وإنما وصلت في هذه الترجمات أو وصلتنا وقد كتبت عربية بحرف عبري .
وعي الحضارة الغربية بأهمية ترجمة التراث العربي والإسلامي: وهنا لابد من الإشارة إلى ريموند رئيس أساقفة طليطلة الذي أسس مجمع المترجمين، وجعل على رأسه دومنيك كوندزلفي. وظهرت الترجمات الأولى وتلتها محاولات ترجمة ابن سينا ورسائل الكندي والفارابي. كما كان لجامعة باريس وتولوز ومونبلي وأكسفورد وجامعة بادو دور كبير في الترجمة.
7- ما هو مستقبل الحوار بين الغرب والإسلام؟
* نأمل أن يكون مستقبل الحوار بين الغرب والإسلام في أحسن حال. فما ما يجمع الحضارتان العربية والغربية أكثر مما يفرقهما. هناك أولا علاقة الجوار . فالمغرب لا تفصله عن أوروبا سوى أربعة عشر كلم والكثير من الدول العربية والإسلامية تطل على الغرب. ثانيا علاقة الاحتكاك الذي يعود إلى العصور القديمة (الرومان واليونان). ثم تعززت هذه العلاقة بظهور المسيحية في فلسطين وانتقالها إلى الغرب بعد ذلك. وعلى الرغم من التحريف الذي طرأ على المسيحية فإنها تبقى مع ذلك ديانة سماوية. وهناك ما يسمى بالمشترك الديني. ولا شك في أن المسيحية أقرب إلينا من باقي الديانات الوضعية أو الفلسفات الشرقية. يجب التركيز على هذا المشترك الديني والبحث عن القيم الإنسانية المشتركة. إذا ما عقدنا على سبيل المثال مقارنة بين الصلاة في الديانات الثلاث فأننا سنقف على عناصر اختلاف كبيرة بين المسيحية من جهة واليهودية والإسلام من جهة أخرى. لكن خلف هذا الاختلاف الذي يُعتبر طبيعيا ومفهوما تكمن مقاصد متماثلة تتمثل في أن المؤمن، وبصرف النظر عن العقيدة التي يؤمن بها، يتوجه في وضعية خضوع وإذلال وتوسل نحو الإله خالق الكون. تتباين اللغات. أما الرسالة فهي واحدة. وما قلناه بشأن الصلاة ينطبق على باقي العبادات الأخرى من صوم وحج وزكاة.
ضرورة البحث عن أرضية للتفاهم. وتجنب الإساءة إلى الأديان أو الأجناس أو الثقافات. فنحن بحاجة إلى الغرب والغرب بحاجة إلينا. ويجمعنا بصرف النظر عن ادياننا الانتماء الى الإنسانية أو ما يُعرف بالمشترك الإنساني.
في الماضي كان الغرب مسيحيا باستثناء أقلية يهودية. أما الآن فالصورة تغيرت تماما فقد بلغ مجمل أعداد المسلمين لوحدهم بأوروبا 42.967,000 سنة 2011. وهو الأمر الذي يضع على عاتق أوروبا مسؤوليات جديدة. لعل أكثرها أهمية هو الإنصات إليهم، واعتبارهم جزءا من النسيج الاجتماعي الأوروبي. ومن واجبنا نحن العرب والمسلمين أن نخوض معركتين في آن واحد: مقاومة كل أنواع التمييز والإقصاء والانغلاق في مجتمعاتنا الأصلية وتحسين صورتنا في الغرب والترويج لها بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
8- تحدثنا حتى الآن عن حوار الحضارات والأديان في سياق العلاقة بين الغرب والإسلام. لكن ما هو موقع المغرب من هذه الحركية؟
* استطاعت المملكة المغربية على عهد المغفور له الحسن الثاني أن ترسم لنفسها مسارا بين دول العالم تميز على وجه الخصوص، بانفتاحها على الثقافات والحضارات واللغات الأخرى، وبإطلاقها لبرامج واعدة في حوار الحضارات والأديان. وتمكن المغفور له الحسن الثاني بحكمته المعهودة، وبعبقريته السياسية النادرة، وببعد نظره الثاقب أن يُروج لمفهوم حوار الحضارات والأديان، وأن يدافع بشراسة في المحافل الدولية عن وسطية الإسلام مُسديا بذلك خدمات لا تقدر بثمن للعالم الإسلامي.
وتجسدت هذه السياسة الرشيدة في إسهام المغرب في أنشطة حوار الأديان التي تُعقد بالخارج، وفي تنظيمه لندوات ومؤتمرات وملتقيات دولية ذات علاقة بحوار الأديان، وفي انخراطه الفعال في المنظمات الدولية التي ترعى قيم الحوار، وفي استقبال المغفور له الحسن الثاني لبابا الفاتيكان من أجل التشاور والحوار، وفي الحفاظ على المكتسبات الدينية لليهود المغاربة.
وصار الملك محمد السادس نصره الله على نهج المغفور له الحسن الثاني. غير أن الخطوة العملاقة تجسدت في دستور 2011 الذي أكد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية تتميز بتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وعلى الرغم من تركيز الدستور الجديد على الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. إلا أن ذلك ينبغي أن يكون في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. وحتى لا تبقى مثل هذه المفاهيم مجرد أماني جميلة أو أهدافا مسطرة فقد أمر الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 6 فبراير 2016 الحكومة بمراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية في مختلف مستويات التعليم، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق.
9- عمليا هل تحقق كل شيء في مجال ترسيخ قيم الحوار بين الحضارات والأديان؟
* ينبغي التنويه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أدرجت في المؤسسات التابعة لها بعض المواد من قبيل علم مقارنة الأديان، واللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة اللاتينية وعيا من مسؤوليها بأهمية مثل هذه اللغات في تطوير علم الأديان، والانفتاح على مختلف الحضارات والثقافات. أما علم مقارنة الأديان في المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي، باستثناء كلية أصول الدين، فهو مبادرات فردية لبعض الأساتذة، ولا يحظى بأي دعم. بل كثيرا ما يحارب للأسف الشديد، من قبل بعض الجهات المحسوبة على بعض التيارات السياسية.
10- ألا تلاحظين وجود مفارقة في المغرب بين الدعوة إلى الحوار بين الحضارات والأديان وغياب كلية للأديان مثلما هو الحال في أوروبا؟
* هذه ملاحظة في محلها. فالمغرب يمتلك الآن كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتأسيس كلية للأديان. فعلى مدار العقود الماضية استطاع المغرب بفضل بعض رجالاته ونسائه وبإمكانيات تكاد أن تكون منعدمة أن يكون العشرات بل المئات من الباحثين المتخصصين في هذا العلم أو في غيره من العلوم المساعدة من تاريخ قديم ولغة عبرية وفلسفة دين وعلم اجتماع الأديان وتاريخ الحضارات وعلم مخطوطات. لقد طالبنا في الكثير من المناسبات بتأسيس كلية للأديان. الحاجة إليها أصبحت ضرورة ملحة. فمعرفة الأديان الأخرى لا تقاوم فقط الفكر الإقصائي وخطاب الكراهية المستشريين في أوساط الشباب، وإنما تساعد السفراء والخبراء الذين يمثلوننا في إدارة دفة التفاوض.
المرجع برنامج قضايا فكرية عنوان الحلقة : فرص الحوار الحضاري في تحقيق التقارب البناء بين الحضارتين الإسلامية والغربية. قناة السادسة.